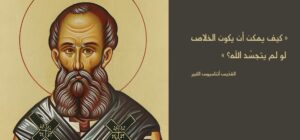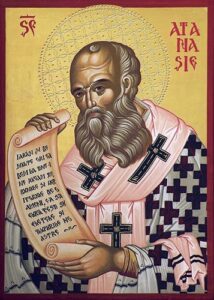
في هذا اليوم تُقيم الكنيسة المُقدَّسَة تَذكار:
* تذكار أبينا الجليل في القدّيسين أثناسيوس وأبينا الجليل في القدّيسين كيرلّلس، رئيسي أساقفة الإسكندريّة العظيمين * الشّهداء ثيوذوليس ورفاقها * الشّهيدة كسينيا * القدّيس مكاريوس الصّربيّ، أسقف فلاخيا.
* * *
✤القدّيس أثناسيوس الكبير معلّم المسكونة (+ 373 م)✤
في الخدمة اللّيتورجيّة
في خدمتنا اللّيتورجيّة اليوم تبرز ملامح صورة معبِّرة ترسمها الكنيسة لهذا القدّيس العظيم. فهو ذو الجلادة والرّاعي الحقيقيّ والقاعدة غير المتزعزعة لكنيسة المسيح. وهو المُلهَم من الله وخادم الأسرار والذّهب الخالص الّذي كانت له الأحزان ومصارعات الأعداء بودقة كريمة، والّذي صاغته كلمة الله خاتمًا ليمينها المُقدّسة. وهو بوق الكنيسة وقاطع مواكب البدع بقوّة الرّوح والمُتكلّم باللّاهوت شاروبيميًّا. وهو روْض أقوال الكتب المُلهَمَة من الله الّذي نقّى نفسه وجسده من كلّ دنس فظهر هيكلًا لائقًا بالله. في قانون السَّحَر قال عنه ثاوفانس المُرنّم: “إنّني بتقديمي المديح لأثناسيوس، كأنّي أمدَحُ الفضيلة، أَظهرُ بالحريّ مقدِّمًا النّشيد لله، الّذي من لدنه قد مُنح هو للبشر موضوعًا مستوجبًا الثّناء للفضيلة الّتي أصبح لها مثالًا حيًّا ونموذجًا”. وقد أحرز المسيح وتكلّم بلسانه وجلا كلمة الإيمان ونفى الضّلالة لما نُفي بتواتر من أجل الثّالوث. دافع عن مساواة الابن والرّوح القدس للآب في الجوهر وأقصى ضلالة آريوس ذات الإلحاد. وهو بهجة رؤساء الكهنة وعمود النّور وقاعدة الكنيسة والكاتب المُدقِّق عن شريعة العيشة الانفراديّة.
فمَن هو تفصيلًا، هذا الّذي استحقّ أن تسبغ عليه الكنيسة المقدّسة كلّ هذه الأوصاف الجليلة وأكثر؟
وسطه ونشأته
لا نعرف تمامًا متى كانت ولادته. نعرف فقط أنّها كانت في حدود العام 295 م. كذلك لا نعرف أين كانت. ثمّة ما يبعث على الظّنّ أنّه ربّما وُلد في مكان ما بقرب مدينة الإسكندريّة، ممّا يُفسّر إلفته بآباء البرّيّة وتعلّقه بمثالهم. أنّى يكن الأمر فالبادي أنّه كان قبطيًّا أكثر ممّا كان يونانيًّا. وقد أشار القدامى إلى السّمرة غير العاديّة لبشرته. كان يقرأ ويكتب ويعظ بالقبطيّة. هذا لا شكّ فيه. لم يعرض لاضطهاد المسيحيّين في سنواته الخمسة العشر الأولى من حياته. حملة ذيوكليسيانوس قيصر على المسيحيّين امتدّت من السّنة 303 إلى السّنة 311 م. ماذا كان وقعها عليه؟ لا نعلم بالتّدقيق، لكن، هناك مَن يميل إلى الرّبط بعامّة بين تشبّث الشّهداء بالإيمان وصلابتهم، من ناحية، وما أبداه أثناسيوس في صراعه ضدّ الآريوسيّة، من ناحية أخرى، من أمانة وصلابة وطول باع. فالواضح أنّ نفسه كانت مطبوعة على روح الشّهادة للرَّبّ يسوع. وقد سرى عنه، عبر العصور، في هذا الشّأن، قول جرى مجرى المثل الشّائع يوم كادت الآريوسيّة تبلع العالم: “أثناسيوس ضدّ العالم. Athanasios contra mundum”.
ماذا عن علمه وثقافته؟ لا نعرف الكثير. يبدو أنّه لم يتثقّف بثقافة اليونانيّين نظير كبار القدّيسين كباسيليوس الكبير والذّهبيّ الفم وغريغوريوس اللّاهوتيّ. الكنيسة تعلّمها، بصورة خاصّة، من الكأس المُقدّسة، من المعلّمين المسيحيّين وأوساط المؤمنين والدّوائر الأسقفيّة في الإسكندريّة حيث يبدو أنّه انضمّ حدثًا إلى حاشية القدّيس ألكسندروس، أسقف المدينة. بعض معلّميه، على ما أورد هو عبورًا، قضى في زمن الاضطهاد. هذا ربّما فسّر حدّة روح الشّهادة لديه.
وقد شاعت عن كيفيّة التصاقه بأسقف الإسكندريّة، ألكسندروس، رواية مفادها أنّه فيما كان الأسقف، يومًا، في دارته المُطلّة على البحر، لاحظ، في المدى المنظور، على الشّاطئ، حفنة من الأولاد يلعبون. كان واحد منهم يقف في الماء فيما كان رفاقه يتقدّمون واحدًا واحدًا كما في زيّاح، فيصبّ عليهم الماء وينصرفون. فأخذ الأسقف يتساءل: ترى ماذا يفعلون؟ وبدافع الفضول أرسل في طلب الولد وسأله ماذا يعمل؟ لماذا يصبّ الماء على رؤوس الأولاد الآخرين؟ فأجابه: أُعمّدهم! – وهل تعلم كيف؟ – نعم! علّمتهم أسرار إيماننا ولقّنتهم الصّلوات وكيف يستعدّون لاقتبال المعموديّة ثمّ عمّدتهم! الأولاد بالمُناسبة، كانوا وثنيّين. فتعجّب الأسقف وأكبر ما فعله الصّبيّ. وإذ مال إليه ورغب في تبنّيه استأذن والديه وضمّه إليه. وبعد سنوات قليلة أضحى مقدَّمًا عنده كابن لأبيه وحافظ سرّه.
ملامحه
كيف بدا للعيان ذاك الّذي أبدى من الجرأة والصّلابة ما أدهش العالم؟ كان نحيف البنية، قصير القامة. أعداؤه دعوه قزمًا. وكان معكوف الأنف، صغير الفم، ذا لحية قصيرة محمرّة وبشرة تميل إلى السّواد وعينين صغيرتين… وقد اعتاد أن يمشي بانحناءة بسيطة إلى الأمام ولكن برشاقة ولباقة كأنّه أحد أمراء الكنيسة.
أثناسيوس وآريوس: أوّل الغيث!
سنة 318 م، وبناء لطلب ألكسندروس، كتب أثناسيوس، وهو بعد في أوائل العشرينات من عمره، مقالتين إحداهما ضدّ الوثنيّين والأخرى بشأن تجسّد كلمة الله. تضمّنت المقالتان لبّ الرّسالة الّتي شاء الرَّبّ الإله لأثناسيوس أن يفتّقها وينقلها إلى العالم. وحدث في السّنة 319 أن دعا ألكسندروس إلى اجتماع لكهنته عرض فيه لوحدة الآب والابن والرّوح القدس في الجوهر، فلم يرق كلام الأسقف لأحد الكهنة الحاضرين، وهو آريوس، الّذي اعترض وطعن في وحدة الجوهر الإلهيّ قائلًا: “إذا كان الآب قد ولد الابن فلا بدّ من أن يكون المولود ذا بداءة في الوجود، وهذا معناه أنّه كان هناك وقت لم يكن فيه الابن موجودًا. ومعناه أيضًا أنّ الابن اقتبل جوهرًا من العدم”. قول آريوس هذا استتبعه اعتبار الابن دون الآب ولو سما على الإنسان. ومن جوهر غير جوهر الآب، وأنّ دوره بين الله والإنسان لا يتعدّى دور الوسيط. وكل ما أُسبغ عليه من تسميات، كالسّيّد والمخلِّص والإله، إنّما أسبغ عليه مجازًا، من باب التّوسّع. ألكسندروس استفظع وحاول ردّ آريوس عن غيّه عبثًا. كثيرون، محليًّا، تدخّلوا ولكن على غير طائل. آريوس عاند وتمادى. وقليلًا قليلًا بدأ أثناسيوس يلعب الدّور الأبرز في الصّراع. تكلّم عن ألكسندروس. واجه آريوس بقوّة ودون هوادة. أمّا ألكسندروس فأطال أناته على آريوس بما فيه الكِفايَة، ولمّا تبيّن له أنّه لم يعد هناك مجال للعلاج جمع أساقفة مصر وليبيا وحكم بقطع آريوس. كان الموضوع خطيرًا. كلّ وحدة الله كانت مهدّدة. كلّ التّدبير الخلاصيّ بيسوع المسيح أضحى بلا معنى. استقامة الرّأي باتت في خطر!
مَن كان آريوس؟
كان آريوس ليبيًّا، راعيًا لكنيسة بوكاليس. لا نعرف عنه الكثير. كتاباته أكثرها أُتلف أو ضاع. كان حادّ الذّهن، ضليعًا في الفلسفة، خبيرًا في الاستدلال المنطقيّ. وقد وُصف بأنّه طويل القامة، نحيف، متنسّك، واثق من نفسه، يتكلّم كمَن له سلطان. كان في الثّالثة والسّتين حين قاوم الأسقف ألكسندروس. وقد سبق له أن التصق، لبعض الوقت، بجماعة منشقّة تمتّ إلى أسقف يُدعى ملاتيوس بلبلت الكنيسة في الاسكندريّة. وثمّة مَن يقول إنّه كان رجل طموحات ويطلب المعالي، فلمّا خاب عن بلوغ سدّة الأسقفيّة الأولى على مصر، تحوّل إلى مقاوم ومعاند إثباتًا لنفسه. أنّى يكن الأمر فقد تعاطى آريوس الحقائق الإيمانيّة كما لو كانت مسائل فلسفيّة. الموضوع بالنّسبة إليه كان موضوع منطق واستنتاجات منطقيّة، على مذهب بعض التّيّارات الفلسفيّة في زمانه. ولكي يجعل آراءه على كلّ شفّة ولِسان نظم بعضها على الموسيقى فأضحت أغان تردّدها العامّة في كلّ مكان.
البدعة تنتشر
وشاعت البدعة هنا وثمّة. كان فيها ما يستهوي. كثيرون تعاطوا المَسيحيّة أو كانوا مُستعدّين لأن يتعاطوها كفلسفة جديدة. وكثيرون سعوا إلى المُزاوجة بين المسيحيّة وهذا التّيّار الفلسفيّ أو ذاك وفشلوا. عشرات الهرطقات تولّدت وعشرات المذاهب نشأت كان يمكن أن تودّي بالكنيسة الفتيّة إلى التّهلكة أو تجنح بها إلى الفساد لو لم يكن روح الرَّبّ حافظها وعاصمها. هذا إذن كان المناخ الفكريّ العام، آنذاك، لا سيّما في أوساط المفكّرين المَسيحيّين. فلمّا نزلت هرطقة آريوس إلى سوق الأفكار، وهي أسوأ وأخطر ما ظهر، تلقّفها العديدون. تجدر الإشارة، على رأي بعض الدّارسين، أنّ للآريوسيّة بصورة أساسيّة، علاقة بالغنوصيّة الّتي يبعد فيها الكائن الأعظم عن المخلوقات، وبالأفلاطونيّة الجديدة الّتي تبدو فيها الكلمة في وضع الوسيط بين الواحد والمُتعدِّد، بين الرّوح والمادّة، وبالمُخفضين، أمثال أوريجنيس المعلّم، الّذين خفّضوا مرتبة الابن ومرتبة الرّوح القدس فقالوا بثالوث متدرّج غير متساوٍ في الجوهر الواحد. إلى ذلك احتضن آريوس وقدّمه عددٌ من المتنفّذين نظير أفسافيوس، أسقف قيصرية فلسطين، وأفسافيوس أسقف نيقوميذية، العاصمة الشّرقيّة للأمبراطوريّة قبل القسطنطينيّة، وبولينوس، أسقف صور، وأثناسيوس، أسقف عين زربة، وغريغوريوس، أسقف بيروت، وماريس، أسقف خلقيدونية. آريوس خرج من مصر إلى قيصريّة فلسطين ومنها إلى نيقوميذية. ومن هناك أخذ يبثّ سمومه يمينًا ويسارًا فاحتدم الصّراع. مصر، ليبيا، فلسطين، آسيا الصّغرى وسواها كلّها اضطربت. قطبا الصّراع كانا مصر ونيقوميذية. لكن، شيئًا فشيئًا كلّ الأساقفة دخلوا في جدل فيما بينهم. دخلوا في صراع. والصّراع طال الشّعب. في بعض الأمكنة تحوّل الجدل إلى صدام فتضارب النّاس وتقاتلوا وسالت الدّماء. هكذا لاح في الأفق، بصورة جدّية، خطر الحرب الأهليّة، فكان لا بدّ للسّلطة الحاكمة من أن تتحرّك لتحسم الأمر وتضع حدًّا للجدل.
مجمع نيقية
بلغت أصداء الصّراع النّاشب أسماع قسطنطين الملك فتنبّه وتخوّف. لم يدرِ تمامًا ما الّذي كان القوم يتجادلون في شأنه. استعان ببعض أصدقائه ومستشاريه العارفين أمثال هوسيوس، أسقف قرطبة. وبعد التّداول معهم استقرّ رأيه على الدّعوة إلى مجمع يضمّ أساقفة المَعمورة يكون دورهم، بصورة أساسيّة، أن يحدِّدوا له موقف الكنيسة الجامعة من المسائل المطروحة وهو يلتزمه ويكفل فرضه بالقوّة. همّ قسطنطين الأوّل كان الحفاظ على الهدوء والنّظام ووحدة الأمبراطوريّة.
على هذا الأساس، تقرّر أن يكون مكان الاجتماع مدينة صغيرة تدعى نيقية، وهي إزنيق الحديثة، في القسم الشّمالي من آسيا الصّغرى، على بعد أميال قليلة من مدينة نيقوميذية. كما وجِّهت الدّعوة إلى ألف وثمانمائة أسقف لحضور المجمع، ووضعت وسائل النّقل الرّسميّة في تصرّفهم. لا نعرف تمامًا عدد الّذين لبّوا. في تراثنا أنّهم 318 على عدد الخدّام الّذين تمكّن إبراهيم الخليل بهم من فكّ أسر ابن أخيه لوط، في سِفْر التّكوين (14: 14).
التأم المجمع في 14 حزيران سنة 325 م. عدد كبير من الكهنة والشّمامسة رافقوا الأساقفة. ستّة أساقفة وكاهنان أتوا من الغرب والباقون كانوا شرقيّين. بعض الّذين حضروا كانوا معترفين حملوا في أجسادهم سمات الآلام لأجل اسم الرَّبّ يسوع: بولس أسقف قيصريّة ما بين النّهرين، ذو اليدين المحروقتين المعطوبتين، وبفنوتيوس الصّعيديّ المقلوع العين اليُمنى والمَعطوب الرّجل اليسرى، وبوتامون الهرقليّ الأعور. كما حضر أساقفة عُرفوا بقداسة السّيرة كسبيريدون القبرصيّ ويعقوب النّصيبينيّ. القدّيس أثناسيوس الكبير كان رئيس شمامسة ورافق أسقف الاسكندريّة ألكسندروس وتكلّم باسمه. مَن رَأَس المجمع؟ لا نعرف تمامًا. ربّما هوسيوس أسقف قرطبة وربّما أفستاتيوس، أسقف أنطاكية. في خطبة إفتتاحيّة، دعا قسطنطين الملك الحاضرين لإزالة أسباب الشّقاق من بينهم وتوطيد السّلام.
عرض آريوس أفكاره، فتصدّى له الفريق الأرثوذكسيّ. أثناسيوس، ولو شمّاسًا، كان الأبرز في الرّدّ على آراء آريوس والتّصدّي لحججه وتبيان عطبها. ساد اللّغط. تبلبلت الآراء. احتدم الجدال. اقترح هوسيوس وضع دستور إيمان يكون أساسًا للإيمان القويم. في ضوء تعاليم الآباء، جرى اعتماد نصّ يشكّل أساس دستور الإيمان النّيقاوي القسطنطينيّ الّذي نتلوه اليوم. الفريق الآريوسيّ تقزّم. استبانت مفسدة آريوس جليّة للعيون. حكم المجمع بقطع آريوس. تبنّى قسطنطين الملك قرارات المَجمع وأصدر قرارًا، على ما ورد عند المؤرّخ سقراط، قضى بحرق كتب آريوس وحذّر مَن يقتنيها سِرًّا ويروّج لها بالموت. انفضّ المجمع بعد حوالي سبعة أسابيع من انعقاده، يوم الخامس والعشرين من تمّوز.
يومَها ظُنّ أنّ ملف آريوس طُوِيَ وأنّ الكنيسة استراحت والأمبراطوريّة استكانت إلى وحدتها من جديد. ولكن، أثبتت الأيّام أنّ ما جرى لم يكن سوى حلقة في مسلسل الآلام الّتي حلّت بالكنيسة الجامعة وبالقدّيس أثناسيوس الكبير كرمز لها، إن لم يكن رمزها الأوحد، على امتداد سنين طويلة.
قول أثناسيوس
التّركيز في دفاع أثناسيوس كان على تراث الكنيسة وتعليمها وإيمانها كما سلّمه السّيّد وكرز به الرّسل وحفظه الآباء. في مُقابل مُيول مناهضيه العقلانيّة قدّم قدّيسنا الإيمان على العقل. أرسى أسس الفكر اللّاهوتيّ القويم كما لم يفعل أحد من قبله. من هنا فضله ومن هنا تسميته في تراثنا بـ “أب الأرثوذكسيّة” أو كما دعاه القدّيس غريغوريوس اللّاهوتيّ “عمود الكنيسة”. كلمة الله، عند آريوس مولود فهو إذن مخلوق، من نتاج مشيئة الآب السّماويّ. عند أثناسيوس، كلمة الله مولود ولكنّه غير مخلوق لأنّه نابع من جوهر الآب لا من مشيئته. هو منه كالشّعاع من الضّوء. ليس فقط أنّ كلّ ما للابن هو للآب بل كلّ ما للآب هو للابن أيضًا. كلّ ملء اللّاهوت هو في الابن كما في الآب. الواحد لا ينفصم عن الآخر. مَن رأى الابن فقد رأى الآب في آن. ليس الآب من دون الابن ولا الابن من دون الآب. كما الضّوء والشّعاع واحد، الآب والابن واحد. لذلك لم يكن هناك وقت أبدًا لم يكن فيه الابن موجودًا وإذا كان الآب والابن واحدًا فالآب مميّز عن الابن والابن مميّز عن الآب. ثمّ وحدانيّة الآب والابن في الجوهر مُرتبطة بتجسّد الابن وبالتّالي بخلاصنا لأنّ الّذي اتّخذ بشرتنا واتّحد بها إنّما أعطانا أن نتّحد به وأن نتّخذ ألوهته. من هنا كلام القدّيس بطرس في رسالته الثّانية (1: 4) عن صيرورتنا “شركاء الطّبيعة الإلهيّة، وكلام القدّيس أثناسيوس نفسه عن كون: “الله صار إنسانًا لكي يصير الإنسان إلهًا”. لو لم يكن الابن من جوهر الآب لما كان بإمكانه أن يجعلنا على مثال الآب. وكما الابن كذلك الرّوح القدس. الرّوح القدس أيضًا من جوهر الآب وإلّا ما أمكنه البتّة أن يؤلّهنا، أن يجعلنا شركاء الطّبيعة الإلهيّة.
الموضوع، بالنّسبة للقدّيس أثناسيوس، كان موضوع الخلاص برمّته. قول آريوس يتعدّى كونه مجرّد رأي لأنّ اقتباله معناه ضرب المسيحيّة في الصّميم. فلا مجال للمُساكنة أو المهادنة. الزّغل في الآراء، في هذا الشّأن، قضاء على الكنيسة. أثناسيوس وعى دقّة المسألة وخطورتها حتّى العظم، فأتت حياته، في كلّ ما عانى على مدى ستّ وأربعين سنة، تعبيرًا عن تمسّك لا يلين بكلمة حقّ الإنجيل والإيمان القويم.
أثناسيوس بطريرك
إثر انفضاض مجمع نيقية، عاد ألكسندروس الإسكندريّ إلى دياره فسام أثناسيوس كاهنًا وسلّمه مقاليد الإرشاد والوعظ وشرح تعاليم المجمع النّيقاوي. ثمّ بعد ثلاث سنوات رقد ألكسندروس (328) فاختير أثناسيوس ليحلّ محلّه. لم يكن الاختيار من دون صعوبات. أثناسيوس كان له مناهضوه، لأسباب عديدة بينها أسباب شخصيّة كفتوّته. كان في الثّلاثين يومذاك. ثمّ إنّ البعض اعتبروه متصلِّبًا قاسيًا تنقصه المرونة في التّعاطي مع الآخرين. أنّى يكن الأمر فقد ورد أنّ قدّيسنا لجأ إلى أحد الدّيورة هربًا من الأسقفيّة لكنّه رضخ، بعد لأي، للأمر الواقع.
أولى مهام أثناسيوس كرئيس أساقفة على الإسكندريّة وتوابعها، كانت استعادة الوحدة والنّظام في أبرشيّته الشّاسعة الّتي عانت لا من الهراطقة الآريوسيّة وحسب بل من جماعة ملاتيوس المنشقّة أيضًا وكذلك من الانحطاط الخلقيّ وانحلال الانضباط الكنسيّ. وعلى مدى سنوات جال أثناسيوس في كلّ الأنحاء المصريّة، حتّى الحدود الحبشيّة، يسيم الأساقفة ويختلط بالمؤمنين الّذين اعتبروه، إلى النّهاية، أبًا لهم. كما تفقّد الأديرة، حتّى الّتي في بريّة الصّعيد، وأقام، لبعض الوقت، في دير القدّيس باخوميوس (15 أيّار). باخوميوس كان يقدّر أثناسيوس كثيرًا، وقد سمّاه، “أب الإيمان الأرثوذكسيّ بالمسيح”.
أقام أثناسيوس الأسقف في شيء من الهدوء يرعى شعبه سنتين. ثمّ انفجر الصّراع مع الآريوسيّة من جديد وعلى أخطر ممّا كان قبل مجمع نيقية.
مسلسل النّفي: الحلقة الأولى
فيما كان القدّيس أثناسيوس يتابع اهتمامه بشعبه كأسقف جديد عليهم، كان الآريوسيّون يحيكون خيوط المؤامرة عليه. حقدهم تفاقم وكَيْدِهم لم يَخبْ. أفسافيوس النّيقوميذي كانت له معارفه في البلاط. أبرز معارفه قسطنسيا، أخت قسطنطين الملك. فسعى لديها لتسعى لدى أخيها لردّ الاعتبار لآريوس. وكان أن صوّر المصوّرون لقسطنطين أنّ قرارات مجمع نيقية لم تأتِ بالثّمار المرجوّة لها لا على صعيد استتباب الأمن ولا على صعيد شيوع السّلام والاتّفاق. لذلك من الأوفق للعرش أن يكون متسامحًا ويدعو إلى التّسامح. هذا يهدِّئ النّفوس ويساهم في الحفاظ على وحدة الشّعب بشكل أفضل. تبنّى قسطنطين هذا المنطق وأعاد لآريوس الاعتبار وسمح له بمزاولة نشاطاته من جديد. إزاء هذا الموقف الأمبراطوريّ المفاجئ، كان ردّ أثناسيوس فوريًّا وحاسمًا: لا! هذا مرفوض! في جوابه إلى الأمبراطور قال: “من المستحيل للكنيسة أن تستعيد مَن يقاومون الحقيقة ويشيِّعون الهرطقة وقد سبق لمجمع عام أن قطعهم”. قسطنطين استاء لأنّه ظنّ أنّ كلمته لا تردّ، بالنّسبة للدّولة كما بالنّسبة للكنيسة. أمّا أثناسيوس فلم يكن همّه الطّاعة لقيصر دون قيد أو شرط بل الطّاعة لله أوّلًا وأخيرًا. كان مستعدًّا للتّعاون مع القيصر طالما كان قيصر في خطّ الحقيقة الإلهيّة. أمّا وقد حاد عنها فهو الملوم. ليس أثناسيوس مستعدًّا للرّضوخ للأمر الواقع. الحقيقة الإلهيّة فوق كلّ اعتبار.
على هذا نجح الآريوسيّون في نقل الصّراع من المستوى اللّاهوتيّ إلى المستوى السّياسيّ. لم ينجحوا في محاربة أثناسيوس باللّاهوت فتحوّلوا إلى محاربته بالسّلطة السّياسيّة. أخذوا يصوّرونه كمشاغب، كمَن يشكّل خطرًا على أمن الدّولة. فلا عَجَب إن قال عنه قسطنطين الملك إنّه “رجل وقح ومتعجرف ومفسِد”. وطبعاً عرف الآريوسيّون بما أوتوه من حقد وكَيْد كيف يغيرون صدر قسطنطين عليه بالأكثر. قالوا عنه إنّه يعرقل نقل القمح المصريّ إلى القسطنطينيّة، وقالوا إنّه يفرض الضّريبة على السّفن المسافرة إلى هناك ليدفع لكهنته. وإمعانًا في تشويه صورة أثناسيوس أمام القيصر والعامّة، وجّهوا إليه تهمًا عدّة بينها الزّنى والسِّحْر والقتل. قالوا إنّه اغتصب امرأة واستبدّ بعفافها. وقالوا إنّه قتل إسقفًا من المنشقّين الملاتيّين يدعى أرسانيوس. والآريوسيّون تظاهروا وهم يحملون ذراعًا سوداء يابسة قالوا إنّها لأرسانيوس.
وإذ صادف مرور ثلاثين سنة على تولّي قسطنطين العرش، أراد الاحتفال بالمناسبة بتكريس كنيسة القيامة في أورشليم. ثمّ تمهيدًا لذلك دعا الأساقفة إلى مجمع يُعقد أوّلًا في صور للنّظر في التّهم الموجّهة إلى أثناسيوس. لم يكن أمام أثناسيوس أي خيار، فركب إلى صور هو وخمسون من أساقفته. لكنّ المجمع لم يكن مجمعًا بل محكمة. لذلك لم يسمح للأساقفة المصريّين بالدّخول. فقط أثناسيوس دخل، ودخل كمتّهَم وعومل كذلك. كلّ أعدائه اجتمعوا عليه. وُجّهت إليه شتّى التّهم. ظنّوا أنّهم قضوا عليه. الخناق كان شديدًا. لم يأتوا به ليستمعوا إليه بل ليدينوه. لكنّ نعمة الله أعانته. قالوا إنّه زان وأتوا بامرأة قالت إنّه اعتدى عليها. لكنّ المرأة فشلت في الدّلالة عليه، وتبيّن أنّه لم يسبق لها أن شاهدته في حياتها. قالوا إنّه قتل أرسانيوس، فإذا بأرسانيوس الّذي وصل إلى صور في اليوم السّابق لانعقاد المحكمة، يظهر ذاته فتظهر التّهمة باطلة. قالوا إنّ اليد اليابسة الّتي حملوها هي يد أرسانيوس، فإذا بأرسانيوس يظهر كامل اليدين. إزاء هذه الشّهادات انحلّ عقد المجتمعين على أثناسيوس دون أن ينحلّ حقدهم. وهكذا تمكّن قدّيسنا من التّواري قبل أن يصدروا في شأنه حكمهم الأخير.
واختفى أثناسيوس. ثمّ فجأة ظهر في القسطنطينيّة. أقام في منزل في الشّارع المؤدّي إلى القصر الملكيّ. وإذ كان قسطنطين عائدًا، ذات يوم، إلى قصره، نزل أثناسيوس إلى الشّارع وتقدّم منه، وقسطنطين غير منتبه، وقبض على زمام الجواد الّذي امتطاه وأوقفه عن سيره. لم يكن قسطنطين مُعتادًا أن يوقفه أحد، فنظر مُستغربًا متعجّبًا منزعجًا، فإذا به أمام الرّجل القصير القامة الّذي لم يعرفه أوّل الأمر يقول له: “الله يحكم بيني وبينك بعدما انضممت إلى صفوف المفترين عليّ!” وبدا قسطنطين كأنّه لا يريد أن يسمع المزيد لكن، أردف أثناسيوس: “أطلب منك فقط إمّا أن تدعو إلى مجمع شرعيّ أو أن تدعو محاكميّ إلى مواجهتي في حضورك”. وانصرف قسطنطين. بعد أيّام طلب ملف القضيّة على أثناسيوس ومعرفة الحكم الصّادر في حقّه، كما دعا عددًا من متّهميه لمواجهته لديه، فحضروا وحضر أثناسيوس. أكالوا له تهمًا عدّة لا سيّما فيما يختصّ بالقمح والسّفن المسافرة إلى القسطنطينيّة. دافع أثناسيوس بمنطق رجل الله لا بمنطق أهل العالم. ولكن بدا قسطنطين أكثر استعدادًا للإصغاء لمنطق مَن يتحدّثون بلغة السّياسة والأمن والدّولة وما إلى ذلك. موقف أثناسيوس بان ضعيفًا. لم يرد قسطنطين أن يبتّ في أمره بصورة نهائيّة، فأبقى عليه أسقفًا للإسكندريّة لكنّه حكم بنفيه إلى “تريف” عاصمة بلاد الغال (فرنسا) حيث بقي إلى أن رقد قسطنطين في أيّار 337 م.
يذكر أنّ آريوس، أثناء غياب أثناسيوس عن الدّيار المصريّة، حاول العودة إلى الإسكندريّة فصدّه الشّعب الحسن العبادة فتحوّل إلى القسطنطينيّة. هناك رغب أفسافيوس النّيقوميذي ومَن لفّ لفّه في حشد الجموع احتفالًا بإعادة الاعتبار لآريوس. وإذ خرج آريوس وأصحابه إلى الشّارع قاصدين الكنيسة بزهو وأبّهة وحماس، حدث فجأة ما لم يكن في الحسبان. شعر آريوس بألم في أحشائه، فانتحى جانبًا لقضاء حاجة نفسه فوقع مغشياً عليه ومات.
الحلقة الثّانية
في غضون سنة من وفاة قسطنطين عاد أثناسيوس إلى كرسيّه. القدّيس غريغوريوس اللّاهوتيّ كان حاضرًا ووصف ما جرى. كلّ الإسكندريّة استقبلته. مشى على السّجّاد. اشتعلت أمام البيوت قناديل الزّيت. صدحت المدينة بالعيد والتّمجيد. “لا شيء يفصلنا عن المسيح”. هكذا علّق أثناسيوس. الصّلاة والعبادة اجتاحت مدن مصر في حركة عفويّة جامعة شاملة. وفي طفرة الحماس مئات وآلاف الإسكندريّين خرجوا ليترهبّوا. الجياع أُطعِموا. اليتامى احتُضنوا. واستحال كلّ بيت كنيسة.
ومع ذلك، وفي أقلّ من ثلاث سنوات (340 م)، عاد أثناسيوس إلى المنفى من جديد.
فإثر وفاة قسطنطين الملك توزّعت الأمبراطوريّة على أولاده الثّلاثة، فملك قسطنطين الثّاني على بريطانيا وغاليا وأسبانيا، وقسطنس على اليونان وإيطاليا وإفريقيا وقسطنديوس على آسيا وسوريا ومصر. الأوّلان مالا إلى الأرثوذكسيّة والأخير إلى الآريوسيّة. وقع تحت تأثير أفسافيوس النّيقوميذيّ الّذي جرى نقله إلى القسطنطينيّة وصار أسقفًا عليها. قسطنديوس كان شابًّا في العشرين ملأته شهوة السّلطة. قال عنه مرسلّينوس المؤرّخ إنّه كان يربك الكنيسة بخرافاته وأوهامه. وقال عنه أثناسيوس: “إنّه قُلَّب لا رأي له من ذاته. يأخذ بنصيحة الخصيّ إذا حدث أن كان قريبًا منه. لذلك لا أظنّه سيّئًا. فقط عاجز وسخيف”.
وصدر لأثناسيوس من القسطنطينيّة أمر بمغادرة الإسكندريّة، كما جرى تعيين أسقف آريوسيّ جديد محلّه هو غريغوريوس الكبّادوكي. دخل غريغوريوس بمواكبة عسكريّة. وصل في آذار 340 م. وبوصوله شاع جوّ إرهابيّ. فدُنّست الكنائس ولُوِّثت المذابح وأُوقف رهبان وعذارى وأودعوا السّجون وعُذِّبوا. الإسكندريّة الكنيسة خضعت للاحتلال العسكريّ. أمّا أثناسيوس فتوارى. استقلّ سفينة برفقة أمونيوس وإيسيدوروس الرّاهبَين وارتحل. إلى أين؟ إلى رومية حيث استقبله يوليوس الأوّل أسقفها استقبالًا طيِّبًا. هذا فيما أُوعز لحكّام الإسكندريّة أن يقطعوا رأس أثناسيوس إذا تجرّأ فعاد إلى الدّيار المصريّة.
بقي قدّيسنا في المنفى ستّ سنوات. تلك كانت سنوات مخصبة. أخذ يتنقّل في الغرب بحرّيّة. كان محترمًا ومقدَّرًا من الجميع. وعظ، خاطب الأساقفة، علّم عن نيقية، وقيل كتب، آنذاك، سيرة القدّيس أنطونيوس الكبير الّتي كان لها أثر بارز على الغرب وعلى شيوع الرّهبنة فيه. وتأكيدًا لدعم يوليوس الأسقف لأثناسيوس، دعا إلى مجمع في رومية في تشرين الثّاني 342 زكّى الإيمان النّيقاويّ وأعلن أنّه لا يعترف بغير أثناسيوس أسقفًا على الإسكندريّة. ولم يطل ردّ فعل الآريوسيّين حتّى ورد، فعقدوا مجمعًا مضادًّا في أنطاكية وضع دستور إيمان جديد واتّخذ تدابير قانونيّة خاصّة للحؤول دون إمكان عودة أثناسيوس إلى كرسيّه. على هذا بدا العالم المسيحيّ مقسّمًا إلى غرب أرثوذكسيّ وشرق يرزح تحت نير الآريوسيّة. أخيرًا، سنة 345، اندلعت الثّورة في الإسكندريّة وقُتل غريغوريوس المغتصب. وإذ تنبّه قسطنديوس إلى خطر اندلاع حرب أهليّة هناك تراجع وسمح لأثناسيوس بالعودة، فعاد خلال العام 346 م وقيل 348 م.
الحلقة الثّالثة
ولم ينم الآريوسيّون على الضّيم ولا نام قسطنديوس الملك. خيوط المؤامرة كانت ما تزال بعد قيد الحياكة. همّ الفريق الآريوسيّ ما فتئ تصوير أثناسيوس كعنصر شغب وأنّ استمراره في سدّة المسؤوليّة الكنسيّة خطر على أمن الدّولة. فبقي قسطنديوس مشدودًا. سنة 353 م أُطيح بقسطنس، الأمبراطور في الغرب، وكان قد أُطيح بقسطنطين الثّاني قبله، فخلت السّاحة لقسطنديوس بالتّمام والكمال. أضحى أمبراطور الشّرق والغرب معًا. هاجسه كان أن يحفظ الوحدة السّياسيّة للأمبراطوريّة بأيّ ثمن. هذه الوحدة، بنظره كانت آريوسيّة الطّابع، وأثناسيوس أحد الّذين يتهدّدونها. فجأة وجّهت التّهمة إلى أثناسيوس بالتّآمر على سلامة الدّولة من جديد. فلقد زعموا أنّ أثناسيوس كاتب أحد السّاعين إلى اغتصاب أمبراطوريّة الغرب، وأنّ رسالة، في هذا الشّأن، وقعت في أيدي عملاء قسطنديوس. عليه وصل، صيف العام 355 م، إلى الإسكندريّة مبعوث ملكيّ وطلب من أثناسيوس تسليم سلطاته فرفض. استمرّت محاولات إقناعه ستّة أشهر من دون نتيجة. قالوا لأثناسيوس: اخرج لتسلم مصر، فأجاب: لن يكون لها سلام إذا غادرتها! أخيرًا وصلت الأزمة إلى حدّ المواجهة العسكريّة. دخل الجنرال سيريانوس الإسكندريّة على رأس خمسة آلاف عسكريّ. جاء ليخرج أثناسيوس بالقوّة. وفي 9 شباط 356 م كان أثناسيوس ورعيّته يقيمون السّهرانة في كنيسة القدّيس ثيوناس استعدادًا لسرّ الشّكر في اليوم التّالي. فجأة أحاط العسكر بالكنيسة واقتحموها. كان أثناسيوس في كرسيّه والتّرانيم تملأ المكان. انبعثت الأصوات. تعالى الصّراخ. التمعت السّيوف. وسقط قتلى وجرحى وديسوا. وقف سيريانوس أمام الهيكل فيما انتشر عسكره بين النّاس يمينًا ويسارًا. همّهم الأوّل كان التّعرّف إلى أثناسيوس والقبض عليه. لكنّ الجند استباحوا سرقة الأواني الذّهبيّة وتعرّضوا للعذارى. أمّا أثناسيوس فإذ كان صغير القامة فقد غطّاه عدد من الرّهبان والإكليروس وحملوه ثمّ خرجوا به من الباب دون أن يلاحظهم العسكر وسط المعمعة واختفوا تحت جنح الظّلام. خرج أثناسيوس إلى الصّحراء. الرّهبان حفظوه، وعامّة المؤمنين أيضًا. لكنّه أخذ يظهر من وقت إلى آخر في الإسكندريّة طلبًا لرعاية شعبه بصورة خفيّة. في تلك الفترة بدا كأنّ الكنيسة، شرقًا وغربًا، وقعت تحت نير الآريوسيّة بالكامل لا سيّما وأنّ قسطنديوس كان قد سعى إلى عقد مجمع لصالحها في ميلان ونفى، على أثره، 147 أسقفًا أرثوذكسيًّا رفضوا الرّضوخ له. القدّيس إيرونيموس كتب عن تلك المرحلة قائلًا: “العالم كلّه كان يئنّ ويعجَب لأنّه ألفى نفسه آريوسيًّا!”
ستّ سنوات قضاها أثناسيوس متخفّيًا، لا شكّ أنّها تركت بصماتها عليه. فلقد شاخ! لكنّه لم يلن ولم يحد عن قوله الأوّل، عن إيمان الكنيسة القويم، عن عقيدة نيقية، شعرة واحدة. قدرته، بنعمة الله، على الصّمود كانت خارقة. كانت فيه شعلة إلهيّة لا تخبو. أخيرًا مات قسطنديوس وعاد أثناسيوس مظفّرًا، بعون الله، إلى الإسكندريّة في 21 شباط 362 م. يوليانوس الوثنيّ الجاحد تولّى العرش. وفي سعيه إلى ضرب المسيحيّة أعاد الأساقفة الأرثوذكسيّين إلى ديارهم آملًا في تأجيج الصّراع بين الأرثوذكسيّين والآريوسيّين، ومن ثمّ في إضعافهما معًا لتقوى الوثنيّة على حسابهما وتعود إلى الواجهة من جديد. لكن حساب البيدر لم يكن على حساب الحقلة، فكان نصيب أثناسيوس التّواري والنّفي مرّة أخرى.
الحلقة الرّابعة
بين شباط وخريف العام 362 م، حقّق القدّيس أثناسيوس نجاحات ملفتة. التفّ الشّعب الأرثوذكسيّ حوله. أقام اتّصالات بعدد من الأساقفة الأرثوذكسيّين. بدى لناظريه كلولب لتوحيد الكنيسة. أقام جسورًا مع الفريق نصف الآريوسيّ الّذي وقف وسطًا بين الأرثوذكسيّة والآريوسيّة. أبدى حياله مرونة وتفهّمًا عميقَين. لمّا فهموا حقيقة موقفه تغيّروا وانضمّوا إليه. كلّ هذا وغيره أقلق يوليانوس الجاحد. وحتّى لا يفسح لأثناسيوس في المزيد من المجال لإفساد خططه عليه اتّخذ في حقّه تدابير احترازيّة. وجّه إلى شعب الإسكندريّة رسالة ذكّر فيها بأنّ أثناسيوس سبق أن صدر في حقّه عدد من المراسيم الملكيّة الّتي قضت بنفيه. سجلّ الرّجل، إذًا، غير نظيف، وها هو الآن يهين القانون والنّظام ويتصرّف كأنّه لا قانون. كذلك أكّد يوليانوس أنّه لم يسمح لا لأثناسيوس ولا لسائر مَن أسماهم بـ “الجليليّين”، وعنى بهم المسيحيّين، بالعودة إلى كنائسهم بل إلى بيوتهم وحسب. وبعد أن أشار إلى ما اعتبره “الوقاحة المعهودة” لأثناسيوس الّذي اغتصب، على حدّ قوله، “ما يدعى بالكرسيّ الأسقفيّ”، أنذره بمغادرة الإسكندريّة حال تسلّمه إشعارًا بذلك، وإلّا فإنّ عقابًا صارمًا سوف يُتّخذ بحقّه.
لم يجد قدّيسنا أمامه خيارًا غير الانسحاب من الإسكندريّة. تركها في تشرين الأوّل 362 م. وإذ رأى الرّهبان الّذي رافقوه إلى المركب يبكون قال لهم: “لا تحزنوا! ليست هذه سوى غيمة صغيرة وتعبر!” أحد مراكب العسكر الملكيّ لاحقه واقترب منه. سألوا “أين أثناسيوس؟” أجاب: “ليس بعيدًا عنكم!” ولكن بدل أن يفتّشوا المركب انصرفوا. أمّا أثناسيوس فوُجد بين رهبان صعيد مصر، لكنّه كان ينزل إلى الإسكندريّة حيثما دعته الحاجة. عملاء يوليانوس كانوا يعرفون ذلك لذلك لاحقوه. مرّة كان في مركب يصلّي وكاد أن يقع في أيدي مضطّهديه. قال للأنبا بامون الّذي رافقه: “أشعر بالهدوء في زمن الاضطّهاد أكثر ممّا أشعر في زمن السّلم”. وإذ أردف موجّهًا كلامه إلى صحبه: “إذا ما قُتلت…” قاطعه بامون قائلًا: “في هذه اللّحظة بالذّات قضى يوليانوس عدوّك في الحرب الفارسيّة!” هذا، كما تبيّن فيما بعد، كان صحيحًا. ففي تمّوز 363 م خرج يوليانوس إلى الحرب ضدّ الفرس فقضى بسهم طائش من أحد عسكريّيه ولم يعد.
الحلقة الخامسة والأخيرة
بعد يوليانوس الجاحد تولّى الحكم الأمبراطور جوفيانوس الّذي كان أرثوذكسيًّا. هذا ثبّت أثناسيوس على كرسيّ الإسكندريّة وعامله بإجلال كبير. لكن عمر جوفيانوس كان قصيرًا. ففي أوائل العام التّالي، 364 م، خرج على رأس عسكره إلى حدود بيثينيا، حيث قضى مسمومًا بدخان الفحم الّذي أُشعل في غرفة نومه لتدفئته. على الأثر تولّى الحكم أمبراطوران: والنتنيانوس على الغرب ووالنس على الشّرق. والنس كان آريوسيًّا. والفريق الآريوسيّ كان أضعف من ذي قبل. انتظر والنس إلى العام 367 م ليبادر إلى نفي الأساقفة الأرثوذكسيّين من جديد. أثناسيوس كان من بينهم. توارى مرّة أخرى. وقيل اختبأ أربعة أشهر في مقبرة. ولكن اهتاجت مصر فتوجّس والنس خيفة وأمر باستعادة أثناسيوس فعاد، هذه المرّة، ليبقى.
ساس قدّيسنا رعيّته بسلام سبع سنوات إلى أن رقد في الرَّبّ في 2 أيّار عام 373 م. جملة سنواته أسقفًا كانت ستًّا وأربعين، قضى عشرين منها في المَنفى. لم يُعاين نصرة الأرثوذكسيّة في كلّ مكان، لكنّها تحقّقت بعد سنوات قليلة من وفاته، زمن الأمبراطور ثيوديوس الكبير.
حياة المغبوط أنطونيوس الكبير
من أهمّ ما ترك لنا القدّيس أثناسيوس، كتابة، سيرة القدّيس أنطونيوس الكبير الّذي قال إنّه رآه مرارًا ولازمه طويلًا وسكب في يديه الماء. تاريخ السّيرة حدود العام 357 م، بعد وفاة القدّيس أنطونيوس بقليل. الكتاب موجّه إلى رهبان غير مصريّين، ربما غربيّين، طلبوا من أثناسيوس أن يكتب لهم عن حياة المغبوط لأنّهم رغبوا في أن يعرفوا منه كيف بدأ نسكه، مَن كان قبل ذلك، كيف كانت نهاية حياته، وهل إنّ كلّ ما يُروى عنه صحيح. غرضهم، كما بدا لأثناسيوس، كان الاقتداء بغيرة أنطونيوس. وقد قبل أثناسيوس طلبهم ولبّى رغبتهم لأنّ ربحه كبير حتّى لمجرد ذكر اسم أنطونيوس، على حدّ تعبيره، ولأنّ حياة المغبوط، كما ورد في مقدّمته، “نموذج كاف للنّسك”. ويبدو أنّ مُراسلي أثناسيوس ضمّنوا كتابهم إليه بعض الأخبار الّتي سمعوها عن أنطونيوس. هذه أكّد أثناسيوس صحّتها مُشيرًا إلى أنّها مجرّد غيض من فيض. كما حرص أثناسيوس على جمع معلومات إضافيّة عن أنطونيوس من الرّهبان الّذين اعتادوا زيارته بشكلٍ متواترٍ، أوّلًا ليتعلّم وينتفع هو نفسه وثانيًا ليكون له أن يكتب عنه المزيد. كذلك سعى أثناسيوس إلى التّدقيق في أخبار المغبوط ما أمكنه لكي تكون كلّ الأمور بشأنه حقيقيّة، على حدّ تعبيره. ثمّ ختم بالقول: “إذا ما سمع أحدكم شيئًا أكثر فلا يشكّ في الرّجل، أما إذا سمع أقلّ فعليه ألّا يحتقره”.
هذا والسّيرة أهمّ وثيقة معروفة عن بداءة الحياة الرّهبانيّة. علّق القدّيس غريغوريوس اللّاهوتيّ عليها بالقول إنّها “قاعدة للحياة الرّهبانيّة في شكلٍ سرديّ”. كتبت أوّل ما كتبت باليونانيّة وترجمها أفغريوس الأنطاكيّ إلى اللّاتينيّة تحت عنوان “من أثناسيوس الأسقف إلى الإخوة الّذين في البلاد الأجنبيّة”. هذا ربّما كان إشارة إلى الرّهبان الغربيّين. أنّى تكن حقيقة الأمر فإنّ السّيرة ساهمت مساهمة فعّالة في نشر المثال الرّهبانيّ وأدخلت الرّهبنة إلى الغرب. أوغسطينوس المغبوط أشار في اعترافاته إلى التّأثير الحاسم الّذي كان للسّيرة عليه، بالنّسبة لهدايته، كما أشار إلى اجتذابها العديدين إلى الحياة الرّهبانيّة.
وإلى السّيرة باليونانيّة واللّاتينيّة وردت أقدم نصوصها بالسّريانيّة والقبطيّة أيضًا.
قالوا عنه
لقد قيل الكثير عن أثناسيوس الكبير. القدّيس غريغوريوس اللّاهوتيّ قال “إنّ الله به حمى الإيمان الأرثوذكسيّ وحفظه، في حقبة من أشدّ الحقب التّاريخيّة حرجاً”. وعن كتاباته قال يوحنّا موخوس، في القرن السادس للميلاد، “إذا وجدت مقطعاً للقدّيس أثناسيوس ولم يكن لديك ورق لتنقله فاكتبه على ثيابك”. كذلك كتب القدّيس غريغوريوس اللاهوتي عنه قائلاً: “إذا كنت أثني على القدّيس أثناسيوس فإنما أثني على الفضيلة نفسها لأنّه حوى كلّ أنواع الفضائل. كان عمود الكنيسة ولا يزال مثال الأساقفة. ليس إيمان أحد صادقاً إلاّ بقدر ما يستنير بإيمان أثناسيوس”. هكذا وصف غريغوريوس خُلقَه: “كان متواضعاً حتى لم يجاره أحد في تلك الفضيلة… حليماً، لطيف المعشر يسهل على الجميع الوصول إليه… طيِّب القلب حنوناً عطوفاً على الفقراء… أحاديثه لذيذة تأخذ بمجامع القلوب. توبيخاته بلا مرارة. ومتى أثنى على أحد فلحمله على الكمال… كثير التسامح من دون ضعف، شديد الحزم من دون قسوة… كثير الحرارة والمواظبة على الصلاة، شديداً في حفظ الأصوام. لا يكلّ عن الأسهار ولا عن تلاوة المزامير… يعطف على الصغار ولا يهاب مقاومة عظماء الدنيا وما يأتون من مظالم”.
أثناسيوس، بكلمة، مصارع. لم يخش الضربات وكان مستعداً أن يتقبّلها. دافع عن الإيمان القويم في وجه الأباطرة كما في وجه اللاهوتيّين السياسيّين. كان واثقاً من ربّه وغلبته، ثابتاً في إيمانه وعزمه. لم يردّه عن قول الحقّ ضيق ولا أسكتته عن الشهادة قوّة. تمثّل الأرثوذكسيّة قولاً وعملاً. قريباً من الشعب كان لا أرستقراطياً. أسقفاً للمقاومة، بتعبير عصري. حريصاً على إتمام رعايته وتقدّم سامعيه في سبل الحياة الإنجيليّة. لا يتّسم لاهوته بالتأمليّة الفلسفيّة بل بالصلابة العقدية. لاهوته تأكيد للحقّ الإلهي لا تفكّرٌ نظري فيه. لاهوته حيّ. حتى البلاغة عنده مظهر من مظاهر الالتزام بعمل الله الخلاصي.
كان أثناسيوس كلّياً في قولته وتصميمه. اتّهموه بالتصلّب وقلّة المداراة. والحقّ أنّه كان صلباً لا متصلّباً. أحدياً في توجّهه على نحو حاد واضح. لا يراوغ ولا يناور ولا يداور. الشعب المؤمن والرهبان أدركوا أنّه يقول الحقّ. لم يؤخذوا بفتنته. أخذوا بشهوة الحقّ لديه. أقنعهم لا بمنطقه، بل لأنّهم وثقوا به. هذا كان سرّ بلاغته النفّاذة.
صنع أثناسيوس الكثير. ترك على الفكر اللاهوتي عبر العصور بصمات لا تمّحي. ولعلّ أبرز ما تركه أنّه حال دون تحوّ المسيحيّة عن خطّها الخلاصي التأليهي إلى فلسفة. كما حرّر الكنيسة من ربقة القوى السياسيّة، لا سيما وقد اعتاد الأباطرة الرومان، إلى زمانه، الاستبداد بشؤون العبادة كما بشؤون العباد. كذلك ربط اللاهوت بالتأله وبالنسك، وقدّم في شأنه أنطونيوس المغبوط نموذجاً للإنسان الجديد، فكان أثناسيوس مفصلاً بين الكنيسة كما آلت إليه بكلّ التحديات التي نزلت بها، والكنيسة كما استودعها سيّدها حقه ونفسه لمئات السنين، بعدما انفتح بابها للدنيا على مصراعيه، حتى إلى يومنا هذا.